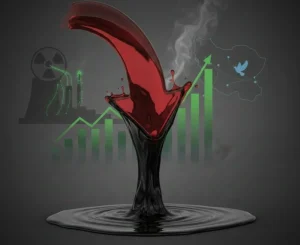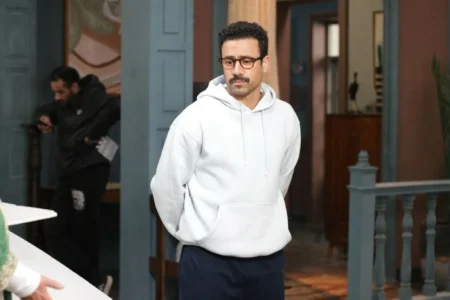وأوضح القادري أنه في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، وفي فورة الشباب، أسس في مدينتي سلا المجاورة للعاصمة الرباط مهرجاناً شعرياً تحت مسمَّى (ملتقى الحساسيّة الشعريّة الجديدة). وكانوا جمهرة من الشعراء الشباب يحدوهم الحماس، ويصلُ بهم الاقتناع إلى أنهم في قطيعةٍ مع من سبقهم من شعراء المغرب، وأنّ لغتهم ورؤيتهم للعالم وللوجود مختلفةٌ عنهم، مشيراً إلى أنه إثر ستّ دورات من هذا المهرجان، اكتشفوا وهْمَ ما كانوا عليه وفيه، وأدركوا أنّ شجرة أنسابهم تضربُ عميقا في تُربة الشعر المغربي، وأنه ما كان لهم أنْ يكونوا لولا الآباء الرّمزيّين للشعر المغربي والعربي الذين عبّدوا لهم الطريق وفرشوه باستعاراتهم وصُورهم وأخيلتهم، بل وبأسئلتهم الثقافية وقلقهم الفكري ومعاناتهم الحياتية ذات الصلة بواقع الكتابة والنشر وحرية التعبير.
فيما يرى الشاعر السمّاح عبدالله، أنه حصيد زرعة رواها الأسلاف، من غير أمطارهم، (ما كان لها أن تورق)، وقال: «لا أظن إلا أن حالي لا يختلف كثيراً عن أحوال المبدعين والمقولة التي أطلقها القاص (محمد حافظ رجب) في الستينيات، «نحن جيل بلا أساتذة»، مقولة غير صحيحة، لأنه هو نفسه كان مرتبكا، إذ عانى كثيراً، ومر بظروف قاسية، والدليل على ارتباكته أنه انقطع عن الكتابة، وعاش في الظلّ بقية حياته»، لافتاً إلى أن المبدع مكمّل لبناء أسسه، وأبناؤه سيكملون عليه، لأنه حلقة في سلسلة، بين الآباء أصحاب الفضل، وبين المجايلين الذين مدوا يد العون، وليس نبتا شيطانيا، مؤكداً أنه لا أقلّ من أن نذكر جميلهم علينا، وفضلهم الذي لو أنكرناه، سنكون جيلاً منقوص الوجدان، كما قال.
فيما عد الناقد محيي الدين جرمة تجربته امتداداً لجيل المؤسسين في الشعرية العربية؛ ومنهم البردوني، وعبد الودود سيف، والمقالح، وعبده عثمان، وعبد الرحمن فخري وآخرون، موضحاً أنه رغم كونه قرأ معظمهم في البدايات بشغف ودهشة من يبحث عن جمرة القصيدة، إلا أن مسارات التجربة أخذت أبعاداً أخرى، لاتجاهات، كون الإبداع يوجد خارج الإطار، أو (التدجن) ومن لم يستطع أن يطور من تجربته بقي مسجوناً وحبيساً في مداجن وشعارات ومناشير وأطر وأيديولوجيات سياسية عفا عليها الزمن. وأضاف جرمة قائلاً: «إجمالاً لم أعد أقف طويلاً ولا مجرد الوقوف عند مفردة جيل، رغم كوني صُنّفت ضمن جيل التسعينيات كما أنجزت أنتولوجيا (خيال يبلل اليابسة) التي وثقت شعريا للتسعينيات بامتداد شعرية لحظتها الراهنة، إلا أنني أردت ذلك كي ألفت الأنظار، والأسماع والشواهد إلى أن أفق التسعينيات في الكتابة في اليمن مثّل دهشة حضور وخصوصية: أشكال وأجيال وتجارب، عايشت تحولات عدة في سياقات الأدب المختلفة، قراءة وكتابة وتأملاً»، وقال: «لا استنكف (شأن بعض الأدعياء) في القول أو الاعتراف، كوني بدأت حفر تجربتي في الكتابة والصحافة الأدبية من مجلة الحائط وبريد القراء في الجريدة اليومية».
فيما أكد الشاعر بلال المصري، أنه لا أحد يأتي من الفراغ، ولتكون كاتباً عليك أن تقرأ للأدباء المخضرمين لتكون معرفتك بتجاربهم الإبداعية التي هي الأساس الذي تبني عليه تجربتك الخاصة، وقال: وما أنا كشاعر معاصر مهما علا شأني أو صغر إلا إضافة صغيرة إلى الإرث الأدبي الكبير الذي ورثناه من الكبار وهذا فضلهم علينا. وعبر عن امتنانه للمجايلين الذي يرى لهم فضلاً كبيراً على المستوى الصداقات، ولكثير من الأدباء الذين مدوا له يد العون في الكثير الأوقات وكان لهم الفضل في كل ما هو عليه اليوم.
فيما يرى الكاتب زياد القحم، أن من الطبيعي أن يشعر المبدع بوجود تأثيرات إيجابية في حياته الإبداعية، وعن تجربته قال «أشعر بأن هناك أسماء من الجيلين لها ذلك التأثير، سواء بشخصها أو بحراكها أو بإنتاجها»، وقال: «سأنحاز إلى جيل الآباء من رموز الإبداع من زاوية أخرى، وهي أن المجايل لي ربما أتبادل معه هذا التأثير الإيجابي، بينما الآباء يمكن تصنيف تأثيراتهم على أنها عطاء أكثر من كونها تبادلا».
فيما ذهب الكاتب محمد نبراس العميسي إلى الاعتراف بفضل الآباء من رموز الإبداع؛ لأنهم مصادر ثابتة وشهود على مرحلتهم الّتي عاشوها، وما شهدته فترتهم الزمنية من تحولات معرفية تُثري حقول الإبداع المعرفية لأجيال العصر. وقال: «كلما تقدم الزمن كلّما ابتعد الناس عن التصورات الجوهرية للإبداع، وكلما تباينوا عن الثوابت والمنطلقات الإبداعية العميقة والواعية لصالح الهشاشة والسطحية والابتذال، وبهذا المعنى أرى أن الآباء رموز خالدة ومنارة مضيئة في حياة الأجيال».
فاطمة إلياس: تأثير يهدد الفحولة الإبداعية
أكدت الناقدة الدكتورة فاطمة إلياس أن جدلية الصراع بين الأجيال كانت وما زالت هي الشغل الشاغل للنقاد الذين ما فتئوا يقارنون بين مبدع ومبدع، ويفاضلون بين جيل وجيل، ويبحثون في خبايا التناص عن أثر لأصوات سابقة يحاول المبدعون أن يتنصلوا من تأثيرها متناسين أن «الأسد ما هو إلا خراف مهضومة» كما قال الفيلسوف والشاعر الفرنسي بول فاليري Paul Valéry، الذي لخص فيها كيميائية هضم هذه الخراف والتوارث الإبداعي بين الأجيال الأدبية، رغم إنكار المبدع أو تنصله، ليأتي بعده الناقد الأمريكي هارولد بلوم ويحلل سيكولوجية المبدع وقلقه من هذا التأثير الذي يهدد فحولته الإبداعية وتفرده. ورغم أن (هارولد بلوم) في كتابه (قلق التأثير: نظرية في الشعرThe Anxiety of Influence: ATheory of Poetry) ركز على الشاعر وسبر أغوار الشعراء الغربيين ومواقفهم من الرواد السابقين، خصوصا المجايلين لهم، إلا أن ما ذكره ينطبق على المبدعين والنقاد في كل عصر وفي كل مكان.
وقالت: هذا ما نراه الآن من محاولات بعض المبدعين طمس أثر من سبقهم من الرواد عليهم، وتعمد تهميش الأحياء منهم، رغم أنهم جيل حفر الصخر، ومهدوا الطريق وكانوا القدوة والنموذج. ثم ما إن اشتد عودهم ونهلوا من الروافد الإبداعية السابقة واللاحقة حتى أداروا ظهورهم لمن سبقوهم، ناهيك عن إنكار أي تأثير إبداعي لهم. وهذا التأثير مهما حاولوا التنصل منه سيظل البصمة التي سيتعرف عليها كل من يحيط بالإرث الأدبي للسابقين، أي أنه كالجينات التي تنتقل من جيل إلى جيل، ومن ثقافة لثقافة عبر القراءة والتواصل المعرفي، لافتةً إلى أن إنكار فضل أو مكانة السابقين يذكرنا بتعنت الشاعر الأمريكي (والاس ستيفنيس) الذي أنكر أنه وقع تحت تأثير أيٍّ من الشعراء لأنه امتنع عن القراءة لأي من الفحول الشعريين السابقين المتفوقين ابداعيا وثقافيا أمثال (تي. اس. اليوت) و(إزرا باوند)، كي لا يتأثر بهم! وهذا جزء من نرجسية بعض الكتاب وصلفهم تجاه الرواد، لأن هذا التأثير المستقر في لا وعي المبدع هو ما يثير قلقه، ويفسر سلوكه تجاه من سبقوه من الرواد المؤثرين، الذي ربما يتطور أحياناً إلى جحود وتقليل من منجزهم! كما نرى الآن في وسطنا الأدبي الثقافي العربي.
وربما يأتي الجحود على مستوى المؤسسات الأدبية، وهو أنكى وأمر من جحود أو تنصل المبدع الفرد، لأن إهمال أو إنكار المؤسسات الثقافية المسؤولة دور الرواد لا يمكن تبريره. وبالنسبة لي أراه جهلاً بسبب تسنم بعض من لا يحيط بتاريخنا الأدبي علماً مسؤولية هذه المؤسسات. وهذا الجهل يظهر في إدارة الفعاليات وما يتخللها من تجاهل غير مقصود لبعض الأسماء الرائدة. وأحياناً تكون الكارثة من بعض المستشارين الذين يرجحون كفة أسماء جديدة ويغمطون حق أسماء رائدة أخرى، ما يكرس لغيابهم، ويعمق الفجوة بين الأجيال.
هنالك جحود للرواد على مستوى المؤسسات، وأقصد به محاولة إزاحة الأندية الأدبية العريقة عن المشهد الأدبي الثقافي، واستبدالها بالمقاهي والكافيهات! وهذه صورة أخرى أمرّ للصراع بين الأجيال! ولكنها تعكس كوميديا سوداء، إذ لا مجال هنا للمقارنة بين الأندية الأدبية العريقة وغيرها من الكيانات الناشئة، التي كان يمكن أن تكون رافداً مستحدثاً من الروافد الثقافية، وإضافة جديدة تصب في الحراك الأدبي الثقافي، لا محو وتجاهل منجزات سابقة، وريادات تاريخية سامقة.